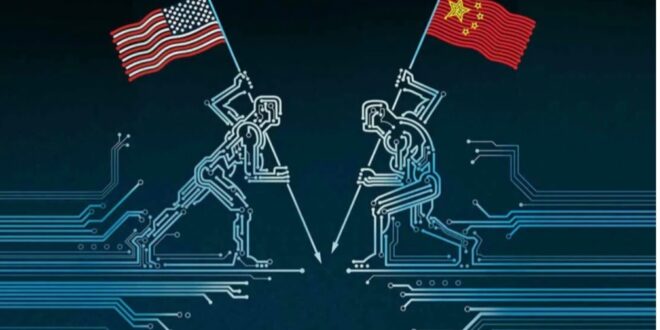يبدو أننا في زمن باتت فيه القيادة التكنولوجية للدول العظمى في العالم، هي التي ستكون المحرك الرئيسي للتأثير السياسي والقوة الاقتصادية، فضلاً عن كونها أحد المحددات الحاسمة للقوة العسكرية.
وهذا ما بيّنت أبعاده، مديرة التنبؤات العالمية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية لموقع ” ذا إيكونوميست – The economist” أغاث ديمارايس، في هذا المقال الذي نشره موقع “فورين بوليسي”.
النص المترجم:
في صيف عام 2020، اندلعت حرائق غابات ضخمة في ولايتي كاليفورنيا وأوريغون. حرائق الغابات تحدث سنويا في المنطقة. لكن وسط الدمار والفوضى، سرعان ما لاحظ الآلاف من رجال الإطفاء الذين يكافحون النيران، أن شيئًا ما كان مختلفًا عن السنوات الأخرى. لم يحدث الاحتراق المنظم، وهو أداة حاسمة لمنع حرائق الغابات، خلال فصل الربيع. كان هناك شيء آخر خاطئ: لم تكن هناك طائرات بدون طيار لمراقبة مدى سرعة انتشار النيران. إذا كان رجال الإطفاء يعرفون سبب عدم وجود حرائق خاضعة للرقابة ولماذا فقدت الطائرات بدون طيار، لكانوا قد فوجئوا على الأرجح، بأنه لا علاقة لذلك بالغابات أو بالسياسات البيئية أو بالتخفيضات الدائمة في الميزانية، بل كان كل شيء يتعلق بالصين.
ففي العام السابق، أمرت إدارة ترامب الوكالات الحكومية الأمريكية بالتوقف عن استخدام أكثر من 800 طائرة بدون طيار، ساعدت في السابق في مراقبة الحرائق، وإجراء عمليات الحرائق خاضعة للرقابة في جميع أنحاء البلاد. عملت الطائرات بدون طيار بشكل جيد، لكنها من صنع شركة DJI الصينية. إن استخدام الطائرات بدون طيار من شركة DJI ليس بالأمر المميز: فالشركة توفر أكثر من 70 في المائة من الطائرات بدون طيار المدنية في العالم. ومع ذلك، كانت الإدارة قلقة من أن الطائرات بدون طيار قد ترسل سرا معلومات حساسة إلى الصين، مما يسمح لبكين برؤية ما يمكن للطائرات بدون طيار رؤيته بالضبط.
أنكرت DJI بشدة هذه الادعاءات، واتخذت خطوات لنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. حذر موظفو وزارة الداخلية الأمريكية من أن وقف الحرائق المراقب سيؤدي على الأرجح إلى حرائق غابات كارثية. ومع ذلك، اختارت الإدارة تجاهل هذه التحذيرات والمضي قدمًا في استراتيجيتها لمنع الصين: أوقفت واشنطن أيضًا الاستحواذ على 17 نظامًا عالي التقنية، تسمى Ignis، والتي تساعد على بدء الحرائق الخاضعة للسيطرة. كانت التكنولوجيا أمريكية. قبل عدة سنوات، أضافت الحكومة الأمريكية Ignis إلى قائمة الابتكارات “المصنوعة في أمريكا”. ومع ذلك، كانت هناك مشكلة: تشتمل أنظمة Ignis على مكونات صينية الصنع. بالنسبة للإدارة، كان هذا مخاطرة كبيرة للغاية.
مع إيقاف الطائرات بدون طيار وفقدان أنظمة Ignis، كان مكتب Wildland Fire الأمريكي قادرًا على تنفيذ ربع عمليات الحرق الخاضعة للرقابة التي رتبت لتنفيذها في عام 2020. كانت الخطة الاحتياطية هي استخدام الطائرات التي يديرها رجال الإطفاء، ولكن سرعان ما تم التخلي عن هذا الخيار: لقد عرّض حياة البشر للخطر عندما كان هناك بديل خالٍ من المخاطر.
كان الافتقار إلى الطائرات بدون طيار دليلًا ملموسًا على الآثار المتتالية للصراع بين الولايات المتحدة والصين. لقد جاءت مع عواقب وخيمة. من غير المحتمل أن يمنع استخدام الطائرات بدون طيار الحرائق، التي كانت بسبب مزيج غير عادي من الرياح القوية والحرارة الشديدة. ومع ذلك، ربما كان من الممكن أن يساعد في خفض عدد القتلى (مات ما يقرب من 40 شخصًا) وتقليل نطاق الضرر (الذي وصل إلى 19 مليار دولار في كاليفورنيا وحدها). هل كان التخفيف من المخاطر التي لا أساس لها من أن الصين قد تستخدم الطائرات بدون طيار للتجسس على الأراضي الأمريكية يستحق مثل هذا الثمن الباهظ؟ بالنسبة لواشنطن، كان الجواب واضحًا على ما يبدو بنعم.
تعود مخاوف واشنطن بشأن الصعود التكنولوجي للصين – والتجسس الصناعي والسرقة الإلكترونية المصاحبة لها – إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ظهرت في المقدمة في عام 2018، عندما أصدر الممثل التجاري للولايات المتحدة تقريرًا مطولًا يلخص جرائم الصين المتصورة ضد الولايات المتحدة. سلطت الوثيقة الضوء على إدراك واشنطن أن الاقتصاد الصيني ليس مدفوعًا بالسوق، ولكنه تقوده الدولة بالكامل. وفقًا للحكومة الأمريكية، تركز الاستراتيجية الاقتصادية للصين على جذب الشركات الأجنبية وسرقة التكنولوجيا الخاصة بها وتوطينها قبل إجبار الشركات على الخروج من السوق الصينية. من وجهة نظر صانعي السياسة في الولايات المتحدة، لا تتضمن هذه العملية سوى بضع خطوات موثقة جيدًا.
أولاً، تجبر الحكومة الصينية الشركات العالمية التي ترغب في الوصول إلى السوق الصينية على تشكيل مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية. هذه الشركات المحلية لديها هدف واحد: سرقة الأسرار التكنولوجية لنظيراتها الأجنبية. هذه قضية معروفة. على حد تعبير المكتب التنفيذي الوطني لمكافحة التجسس، “الجهات الفاعلة الصينية هي مرتكبي التجسس الاقتصادي الأكثر نشاطًا واستمرارية في العالم”. (لكي نكون منصفين، ربما لا تكون الولايات المتحدة متخلفة عن الركب). وبدلاً من ذلك، قد تجبر الصين أيضًا الشركات الغربية على بيع خبرتها لشركائها الصينيين بأسعار منخفضة للغاية.
بمجرد أن تجمع بكين التكنولوجيا التي تبحث عنها، تقوم الشركات الصينية بتكرارها. هذه هي اللحظة الشهيرة عندما تدرك الشركات الأجنبية أن مصنعًا يشبه إلى حد كبير مصنعها قد افتتح للتو على الطريق. الغريب أن المصنع الصيني يصنع نسخًا طبق الأصل من المنتجات الغربية. تعتقد واشنطن أن بكين تخطط في النهاية لطرد الشركات الأجنبية من الصين. هذا منطقي من الناحية النظرية: بمجرد أن تحصل الشركات الصينية على التكنولوجيا الأجنبية، قد لا ترى بكين سببًا يذكر للسماح للشركات الأجنبية المنافسة بالبقاء في سوقها المحلي.
هذه الممارسات غير العادلة معترف بها على نطاق واسع، لكنها لا تشكل سوى جانب واحد من مخاوف الولايات المتحدة تجاه الصين. في السنوات الأخيرة، أصبحت الحكومة الأمريكية أيضًا قلقة بشكل متزايد من أن السماح للشركات التكنولوجية الصينية بالعمل على الأراضي الأمريكية أو جعل الوكالات الحكومية الأمريكية تستخدم التكنولوجيا الصينية الصنع يعرض الأمن القومي للخطر. كان هذا هو السبب وراء تأريض الطائرات المسيرة الخاصة بغدارة الحرائق على الساحل الغربي. ومع ذلك، فإن القضية ليست مقصورة على الطائرات بدون طيار. تذهب الحجة إلى أن جميع شركات التكنولوجيا الفائقة في الصين لها علاقات بالدولة الصينية وقد تضطر إلى جمع البيانات سرًا عن المستهلكين الغربيين.
على الورق، تبدو هذه المخاوف صحيحة. على الرغم من عدم وجود سجلات عامة لمثل هذه الحوادث، إلا أن قانون الأمن القومي الصيني قد يجبر الشركات الصينية التي تعمل في الولايات المتحدة على جمع معلومات عن المواطنين أو الشركات الأمريكية وإرسال هذه البيانات مرة أخرى إلى بكين. لا خيار أمام الشركات الصينية سوى التعاون مع بكين. وفقًا للوائح الصينية، ليس للشركات الحق في استئناف مثل هذه الطلبات. تأخذ العديد من الشركات الأمريكية بالفعل هذه القضايا على محمل الجد. الإمدادات التكنولوجية لغوغل وفيسبوك، على سبيل المثال، يجب أن تكون مقاومة للصين.
من هذا المنظور، فإن أبراج الهواتف المحمولة الصينية الصنع المثبتة بالقرب من المباني الحكومية، مثل المكاتب الفيدرالية أو القواعد العسكرية، تشكل تهديدًا حادًا بشكل خاص. هذا هو لب الجدل حول مشاركة بكين في النشر العالمي لشبكات اتصالات 5G يعتقد صقور الدفاع أن الصين يمكن أن تستخدم البنية التحتية للتجسس على المنشآت الحساسة. يسارع مؤيدو الصين إلى الإشارة إلى أن هذه المخاوف نظرية ولا أساس لها. ومع ذلك، هناك سوابق: في مناسبتين منفصلتين، اتهمت الصين بالتجسس على المقر الإثيوبي للاتحاد الأفريقي. وقد أنكرت بكين والشركات الصينية المشتبه في تورطها الاتهامات، والتي قلل الاتحاد الأفريقي من أهميتها – وإن كان ذلك لأسباب غير قابلة للتفسير.
يبدو السيناريو الأسوأ للمؤسسة الأمنية الأمريكية أكثر إثارة للقلق. يخشى بعض الخبراء من أن تركيب معدات اتصالات صينية الصنع على الأراضي الأمريكية قد يمكّن بكين من سحب قابس الهاتف أو شبكات الإنترنت الأمريكية. يعتقد معظم المحللين أن هذا غير ممكن حقًا. على أي حال، يبدو هذا غير مرجح: سيتراجع نمو الصين إذا انهار الاقتصاد الأمريكي. إذا اتخذت الصين مثل هذه الخطوة المتطرفة، فإن قدرة بكين طويلة المدى على إقناع الدول بتركيب معدات اتصالات سلكية ولاسلكية صينية ستعاني أيضًا. ومع ذلك، إذا تورطت الولايات المتحدة والصين في صراع عسكري مباشر، على سبيل المثال حول تايوان، فلن يكون لبكين ما تخسره.
في الوقت الحاضر، وجهة نظر الحزبين في أروقة السلطة في واشنطن هي أن الصين تطرح نسخة مجددة من الإمبريالية الاقتصادية، تمامًا مثل بريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر أو اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. للاحتفاظ بدورها كقوة عظمى وحيدة في العالم، تعتقد واشنطن أن عليها إيقاف بكين في مسارها. يذهب بعض الأمريكيين إلى حد اعتبار الصراع بين الولايات المتحدة والصين صراعًا بين الأجيال، على قدم المساواة مع الصراعات ضد الاتحاد السوفيتي السابق أو الإرهاب الإسلامي. قد يكون الواقع أقل دراماتيكية. الصراع بين الولايات المتحدة والصين هو صراع للهيمنة الاقتصادية بين قوة اقتصادية عظمى حالية ومنافسها الصاعد.
في هذه الحرب الاقتصادية، لا غرابة في أن الولايات المتحدة حريصة على الاستفادة من جميع أشكال الإكراه الاقتصادي. فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على 360 مليار دولار من الواردات الأمريكية من الصين؛ أوضح الرئيس جو بايدن أنه لن يرفعها. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد صينيين مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور في شينجيانغ والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ. في المجال المالي، يفكر المشرعون الأمريكيون فيما إذا كانوا سيشطبون أكثر من تريليون دولار من أسهم الشركات الصينية في البورصات الأمريكية. يفكر الكونغرس أيضًا في منع خطة التوفير، التي تدير معاشات ملايين موظفي الحكومة الفيدرالية، من الاستثمار في الشركات الصينية.
ومع ذلك، فقد نما الاقتصاد الصيني بشكل كبير للغاية بحيث لا تستطيع واشنطن معاقبة بكين بمجموعة أدواتها المعتادة. ربما تكون الولايات المتحدة قد استكشفت جميع أدوات التجارة المحتملة – الرسوم الجمركية بشكل أساسي – التي يمكن أن تستخدمها ضد الصين. يبدو أن العقوبات المالية أمر مستبعد للغاية؛ من شبه المؤكد أن استهداف ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعقوبات مالية سيؤدي إلى نتائج عكسية. تحتاج الولايات المتحدة إلى شيء آخر لتعزيز مصالحها ضد الصين. لذلك ركزت واشنطن جهودها على قطاع التكنولوجيا.
في عام 2016، أعلنت القيادة الصينية أنها تخطط لإنفاق 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات لتطوير صناعة أشباه الموصلات الصينية. لم يكن الصراع بين الولايات المتحدة والصين قد بدأ بشكل جدي بحلول ذلك الوقت، لكن إعلان بكين أثار أجراس الإنذار في جميع أنحاء مؤسسة الدفاع الأمريكية. حذر الخبراء من أن خطة الصين لتعزيز وجودها في قطاع أشباه الموصلات تعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر: في غضون بضعة عقود، يمكن للشركات الصينية أن تصبح قادرة على تصنيع رقائق إلكترونية أكثر تقدمًا من الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، يمكن أن تصبح الصواريخ أو الليزر أو أنظمة الدفاع الجوي الصينية الأكثر تطورًا في العالم.
أشباه الموصلات هي كعب أخيل للاقتصاد الصيني. تشتري بكين أكثر من 300 مليار دولار من أشباه الموصلات الأجنبية الصنع كل عام، مما يجعل رقائق الكمبيوتر أكبر واردات الصين، أعلى بكثير من النفط. وهذا يعكس حقيقة أن المصانع الصينية تستورد 85 في المائة من الرقائق الدقيقة التي تحتاجها لبناء سلع إلكترونية، ويتم تصنيع معظم أشباه الموصلات هذه باستخدام التكنولوجيا الأمريكية. بالنسبة لواشنطن، يجعل هذا ضوابط التصدير أداة مثالية على ما يبدو لحرمان بكين من الابتكار والدراية الأمريكية. تعمل مثل هذه القيود بطريقة مماثلة للعقوبات المالية: فهي تسعى إلى الحد من وصول الخصوم إلى السلع الأساسية الأمريكية الصنع – العملة الخضراء للعقوبات المالية أو تكنولوجيا رقائق الكمبيوتر لضوابط التصدير – والتي أصبحت حاسمة للغاية بحيث لا يمكن لعدد قليل من البلدان الاستغناء عنها.
تدرك واشنطن أن لديها ورقة رابحة ضخمة لتلعبها في قطاع أشباه الموصلات: تقريبًا كل رقاقة في جميع أنحاء العالم لها ارتباط ما بالولايات المتحدة، سواء كان ذلك لأنها مصممة ببرمجيات أمريكية الصنع، أو تم إنتاجها باستخدام معدات أمريكية الصنع، أو بأدوات أمريكية الصنع. هذا ليس مفاجئًا: الولايات المتحدة هي مسقط رأس صناعة أشباه الموصلات. ولد هذا القطاع في الخمسينيات من القرن الماضي لتلبية الاحتياجات التكنولوجية المتزايدة للجيش الأمريكي حيث بدأ في مواجهة الاتحاد السوفيتي السابق. بعد حوالي 70 عامًا، بلغت القيمة السوقية لشركات الرقائق الدقيقة الأمريكية حوالي 1 تريليون دولار. ببساطة، تهيمن الولايات المتحدة على المجال.
تصنع الشركات الأمريكية حوالي 10 في المائة فقط من رقائق الكمبيوتر المباعة في جميع أنحاء العالم. توجد مسابك الرقائق الدقيقة الرائدة في العالم (كما تسمى خطوط تجميع أشباه الموصلات) في آسيا، وبشكل رئيسي في تايوان وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، فإن حفنة من الشركات الأمريكية تسيطر على جميع المستويات العليا من سلسلة التوريد. بالنظر إلى هيمنة الولايات المتحدة على قطاع الرقائق الدقيقة، تدرك واشنطن أن الإجراءات التي تحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات الأمريكية لديها كل الفرص لتوجيه ضربة لطموحات بكين التكنولوجية.
في عام 2018، بدأ الكونجرس في وضع هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ، حيث تبنى بهدوء سلسلة من اللوائح التي تهدف إلى قطع وصول الصين إلى المعرفة الأمريكية. في أيار / مايو 2019، بدأت إدارة ترامب في فرض ضوابط تصدير على شركة Huawei، عملاق الاتصالات الصيني، مما أرسل موجات صدمة عبر قطاع التكنولوجيا العالمي. اتخذت واشنطن هذه القيود خطوة إلى الأمام في أيار / مايو 2020، عندما أعلنت الإدارة أنها تمنع جميع مصنعي الرقائق الدقيقة من تزوير رقائق لهواوي، في أي مكان في جميع أنحاء العالم، إذا استخدموا التكنولوجيا الأمريكية. بعد ثلاثة أشهر، شددت وزارة التجارة القواعد لحظر جميع مبيعات الرقائق الدقيقة لشركة Huawei. في الفترة المتبقية من العام، وسعت الإدارة القيود لاستهداف العشرات من الشركات الصينية الأخرى؛ ومن بين هؤلاء SMIC، أكبر صانع للرقائق الدقيقة في الصين.
بدت هذه الإجراءات قاسية في ذلك الوقت، لكنها كانت مجرد خطوات أولى. في تشرين الأول (أكتوبر)، وجهت إدارة بايدن ضربة أشد إلى القطاع التكنولوجي في الصين: فبدلاً من استهداف الشركات الصينية البارزة فقط، فرضت واشنطن قيودًا على جميع صادرات الرقائق الدقيقة وأدوات صنع أشباه الموصلات إلى الصين. كما تم تحذير المواطنين الأمريكيين من أنه بدون موافقة صريحة (وغير مرجحة) من الحكومة الأمريكية، فإنهم يخالفون القانون الأمريكي إذا اختاروا العمل لدى شركات التكنولوجيا الصينية.
من نواح كثيرة، تشبه هذه التدابير العقوبات المالية إلى حد كبير. الفرق هو أنه بدلاً من استهداف الشركات العالمية التي تستخدم الدولار، تطبق واشنطن تدابير قسرية على الشركات التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية، بغض النظر عما إذا كانت هذه الشركات أمريكية أو أجنبية. مثل العقوبات المالية، تسعى لوائح التصدير هذه إلى إجبار الدول والشركات على اختيار الجانبين بين الولايات المتحدة والدولة الخاضعة للعقوبات – في هذه الحالة الصين. تراهن الولايات المتحدة على أن أكبر منتجي الرقائق الدقيقة في العالم، مثل Samsung في كوريا الجنوبية أو MediaTek وTSMC في تايوان، سوف يقفون إلى جانبها ويتوقفون عن العمل مع الشركات الصينية. بدلاً من ذلك، يمكن لهذه الشركات الأجنبية أن تحافظ على علاقاتها مع الصين، ولكن هذا سيكون بسعر مرتفع: فقد أصبح استخدام التكنولوجيا الأمريكية لتصميم أو تصنيع الرقائق الدقيقة للشركات الصينية أمرًا مستحيلًا. إن الاستمرار في خدمة السوق الصينية يستلزم الآن إعادة بناء خطوط تصنيع كاملة ومقاومة للولايات المتحدة للعملاء الصينيين بتكلفة تصل إلى عدة مليارات من الدولارات.
لقد أثبتت الآثار المتتالية العالمية لضوابط التصدير ضد الشركات التكنولوجية الصينية أنها هائلة، وربما أكثر مما توقعته وزارة التجارة. اضطرت Huawei إلى إيقاف الإنتاج في عدد من منشآتها، حيث اعتمد الكثير منها على معدات أمريكية الصنع. في مواجهة مستويات عالية من عدم اليقين، خفضت SMIC الإنفاق وخطط الاستثمار. خارج الصين، بدأ مديرو مسابك الرقائق بشكل محموم في التحقق مما إذا كانت معداتهم تستخدم التكنولوجيا الأمريكية. إذا كان هذا هو الحال، فقد أصبح العمل مع عشرات الشركات من الصين، أكبر مستورد لأشباه الموصلات في العالم، غير قانوني.
في بعض الحالات النادرة، لم تعتمد خطوط الإنتاج لشركات التكنولوجيا العالمية على التكنولوجيا الأمريكية. نظريًا، أدى هذا إلى حماية هذه الشركات من الإجراءات الأمريكية. ومع ذلك، كانت واشنطن تعتزم التأكد من أن جميع الشركات الغربية تخلت عن عقودها مع بكين – وهو درس تعلمته شركة ASML الهولندية، التي تصنع آلات قادرة على نحت الرقائق الدقيقة، بالطريقة الصعبة. ضغطت الإدارة الأمريكية على الحكومة الهولندية بشدة للتأكد من أنها ستمنع ASML من العمل مع الشركات الصينية. استسلمت هولندا في النهاية لضغوط الولايات المتحدة وألغت رخصة تصدير ASML إلى الصين.
بالنسبة لبكين، كانت هذه علامة مؤكدة على وجود مشاكل قادمة: الشركة الهولندية هي الشركة الوحيدة في العالم التي تتقن تكنولوجيا الأشعة فوق البنفسجية الشديدة التي يحتاجها SMIC لتصنيع رقائق متقدمة للغاية. بالنسبة للشركة الهولندية، كان هذا التطور أخبارًا سيئة أيضًا. كلفت المعدات أكثر من 20 مليار دولار لتطويرها، وكان السوق الصيني سريع النمو من أكثر الأسواق الواعدة. ألمح الرئيس التنفيذي لشركة ASML لاحقًا إلى أن الشركة كانت تتطلع إلى جعل سلاسل التوريد التابعة لها مقاومة تمامًا للولايات المتحدة.
لم يكن الغرض من ضوابط التصدير ضد Huawei أن يكون لها تأثير محلي، ولكن كان لها أيضًا تأثيرات مضاعفة على الأراضي الأمريكية. لطالما أدرك مزودو الهواتف المحمولة والإنترنت في المناطق الريفية أنهم في ورطة. توقفت معدات Huawei الرخيصة التي اشتروها لتوصيل الأماكن البعيدة وذات الكثافة السكانية المنخفضة بالإنترنت فجأة عن تلقي تحديثات البرامج المهمة أو قطع الغيار من الشركات الأمريكية. كان هذا حكمًا بالإعدام: بدون هذه التحديثات وقطع الغيار، ستتوقف أبراج الهواتف المحمولة وشبكات الإنترنت من Huawei، بمرور الوقت عن العمل ببساطة.
على الجانب الآخر من المحيط الهادئ، تدرك بكين أن إجراءات التصدير الجديدة لواشنطن ستطرح مجموعة من المشكلات الجديدة التي يجب معالجتها. بالنسبة للقيادة الصينية، تعتبر أشباه الموصلات ذات أهمية خاصة في مجالين: تصنيع الهواتف المحمولة ونشر شبكات 5G على الأراضي الصينية. لا يبدو أن الولايات المتحدة عازمة على كبح قدرة الصين على تصنيع الهواتف المحمولة الأساسية الرخيصة، لأنها لا تشكل تهديدًا أمنيًا للولايات المتحدة؛ قام البيت الأبيض بتمديد تراخيص التصدير لعدد من الشركات الأمريكية والأجنبية حتى يتمكنوا من الاستمرار في التعامل مع Huawei لمثل هذه المنتجات غير المتطورة.
ومع ذلك، يبدو أن واشنطن حريصة على تطبيق ضوابط التصدير إلى أقصى حد عندما يتعلق الأمر بالرقائق فائقة الدقة والمتقدمة للغاية. بالنسبة للصين، سيكون هذا صداعًا كبيرًا في السنوات القادمة. تعد الرقائق الدقيقة عالية التقنية مكونًا مهمًا لشبكات اتصالات 5G التي يتم الترويج لها كثيرًا. من المرجح أن يؤدي استعداد واشنطن لتقييد وصول بكين إلى أشباه الموصلات المتقدمة إلى إعاقة تطوير الصين للبنية التحتية للجيل الخامس. من المحتمل أن تكون القيادة الصينية قادرة على إعطاء الأولوية لنشر 5G في عدد قليل من المدن والمناطق البارزة. ومع ذلك، ربما يتعين على بقية البلاد الانتظار لفترة أطول من المتوقع للوصول إلى الابتكارات التي تتيحها شبكات الجيل الخامس، مثل المركبات ذاتية القيادة أو الشبكات الكهربائية الذكية.
من المرجح أن تكون مثل هذه الآثار المتتالية، في كل من الصين والولايات المتحدة، مجرد قمة جبل الجليد. لن تظهر عواقب ضوابط التصدير التي تقيد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية إلا على مدى عدة عقود. يميل الابتكار إلى أن يأتي مع الاستثمارات الصناعية طويلة الأجل التي تنطوي على سلاسل التوريد وعمليات التصنيع المرتبة بدقة. ضوابط التصدير الأمريكية ستغير هذه الخطط.
الشركات المصنعة الرائدة في العالم للرقائق الدقيقة، بما في ذلك TSMC التايوانية (التي تسيطر على حوالي نصف القدرة الإنتاجية العالمية) وشركة Samsung الكورية الجنوبية (المتخصصة في الرقائق الدقيقة الأكثر تقدمًا)، تعيد بالفعل تصميم سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها مع وضع ضوابط التصدير الأمريكية في الاعتبار. تخطط TSMC لفتح مسبك عملاق بقيمة 12 مليار دولار في ولاية أريزونا بحلول عام 2024؛ من المحتمل أن يخدم المصنع المدعوم من الولايات المتحدة السوق الأمريكية فقط، بينما ستستمر مصانع TSMC الأخرى في التعامل مع الشركات الصينية. تعكس أحدث مشاريع سامسونغ أيضًا هذا الواقع الجديد: تخطط الشركة الكورية الجنوبية لبناء مسبكين في السنوات المقبلة، أحدهما في تكساس مقابل 17 مليار دولار والآخر في زيان، في وسط الصين، مقابل 15 مليار دولار.
حتى لو انحسرت التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يبدو مستبعدًا للغاية، فإن الطبيعة طويلة الأجل لبرامج الاستثمار الضخمة هذه تعني أن آثار ضوابط التصدير ستثبت أنها طويلة الأمد ويصعب التخلص منها. سيحدث الصراع الصيني الأمريكي على التكنولوجيا عبر عدة عقود، وربما بعد عام 2050. يبدو أن ضوابط التصدير ستشكل الجزء الأكبر من ترسانة واشنطن للدفاع عن المصالح الأمريكية، خاصة في القطاع التكنولوجي. توضح الإجراءات التحول المتزايد نحو بيئة تكون فيها القيادة التكنولوجية هي المحرك الرئيسي للتأثير السياسي والقوة الاقتصادية، فضلاً عن كونها أحد المحددات الحاسمة للقوة العسكرية.
المصدر: فورين بوليسي – foreign policy
الكاتب: غرفة التحرير
 LRN News جريدة الكترونية شاملة
LRN News جريدة الكترونية شاملة